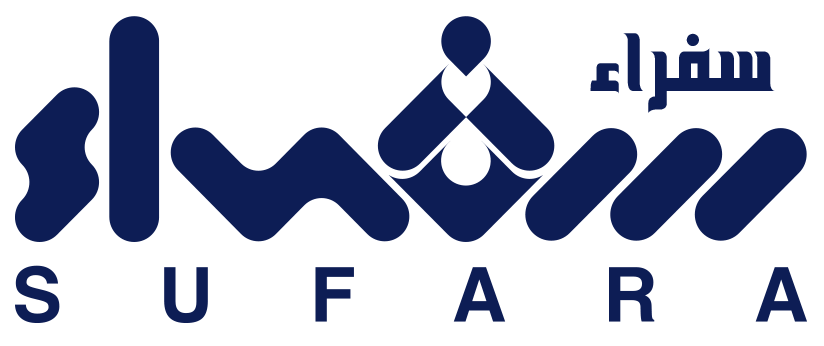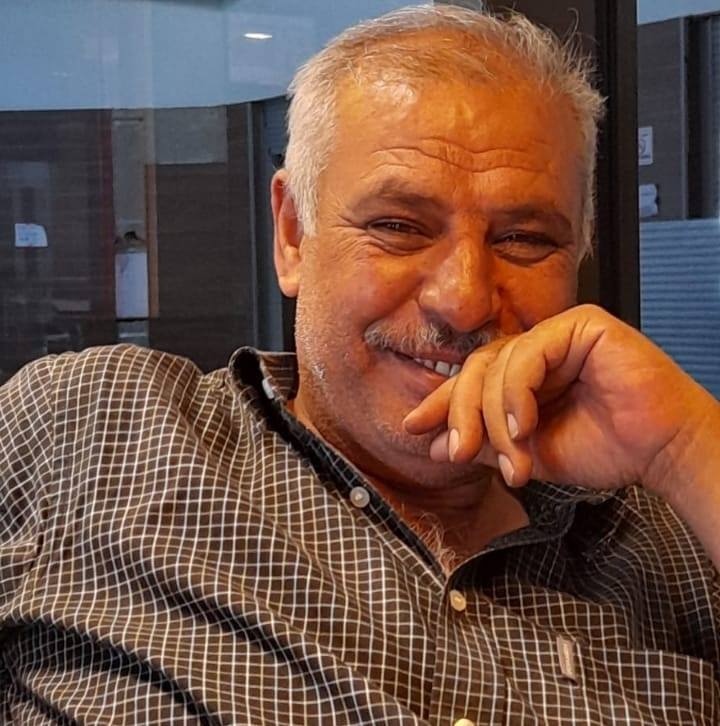في صيف هذه السنة الضنكى على العباد، طلب مني الأستاذ علي سعادة أن أكتب مقدمة لكتابه (وألقيت عليك محبة مني) فشعرت بفضل زمالة تقاطعت فيها بناء الفكرة الراقية، وثقة الأخوة بيننا، بقدرتي على نسج نص مفعم بالمحبة يليق بكتاب خُصص ليرى الإنسانية بعين كاتبة أحبت الله وتدبرت كتابه، إذ كنت أقرأ نصوص الكتاب المتجلي في فلسفة تفسير كيف نرى الله ويرانا !
يزخر كتاب ( وألقيت عليك محبة مني) بثقافة حياتية من منظور عقائدي جميل جدا، إذ يتخذ سعادة من آيات القرآن الكريم تفاصيل صغيرة جدا ليفهم تركيبة السفينة التي ولدنا فيها، بمسمى القدر المبحرة بنا في محيط الحياة ، فتعلمنا أمواج الحياة ورياح القدر أن النضج لا يحتاج حساب للعمر بل حساب لمنظومة أفكارنا، وصياغة مبادئنا، وتأثيرات تكوينات معرفتنا، وأن كل محركات السفينة المبحرة بقدرنا، عليها أن تصل ضفة ما، للاستراحة وللمراجعة والتقييم والتحليل، وأن تلك الضفاف لا ترسو سفينتنا عليها صدفة، وأننا وحدنا من علينا أن نختار وأن الله يراقب خياراتنا ويدفع بالتي هي أحسن، بمشقاتها الكثيرة، وسعادتها الصغيرة، فكلما توسع الإيمان والاحتساب في قلوبنا الصغيرة، كلما فتحنا باباً جديداً، فقيل أن القدر من التقدير، وأمّا القضاء فهو الخَلق، فيكون القدَر بمنزلة الأساس، والقضاء بمنزلة البِناء، وكلما فهمنا مجريات طقس مسيرات السفينة، ومسببات أمواج بحر حياتنا، قدنا السفينة إلى ضفة تهيئ لنا أن نجد فيها شيئا من الحب والخير، فكلنا نعيش الخير والشر، ونحمل الجميل والبشع، الفرق بيننا أن يرابط أحدهم على الخير بصعب الحصول عليه أو يدفع بالسيئة الأسهل .
عندما قرأت كتاب سعادة، رأيت إحسان فلسفة نصوص هذا الكتاب بقلبي، لأتأمل آيات الله التي حللها سعادة، بسعادة وقناعة لأقتنع أن علي أن أكتب مقدمة تعبر عن كم الإحسان والإيثار الذي فاض به كتاب سعادة لأدفع غيري أن يرى الخير بالإحسان، وأن القرآن حمل محبة فائضة، تنير سبيل الضائع والمكلوم والمفجوع، وأن فلسفة المحبة في القرآن تبني أمما منتصبة الكرامة، في زمن طؤطئت فيه الرؤوس، حتى ظننا أن الشرق أضعف من أن يقف مجدداً إلى أن الحقيقة عكس ذلك.
من يتفحص نصوص هذا الكتاب، وتفاسير آيات القرآن بتمعن، يتغير شيء في وجدانه حالا، ما أن يغمض عينيه لليلة الأولى بعد قراءته، لأن إشراقا ما سينير قلبه وسيدفع بالخير فيه ليجود ويتسع على شر النفوس، لنقر أن اليوم الجديد ليس يوما عادياً من عمرك؛ بل هو يوم فيه حل لغز أمنية ما في نفسك، فتسعى في مناكب الأرض لتراها بشكل مختلف، فيفتح الله لك بابا من حيث تحتسب ولا تحتسب، لأن الأصل هو الحسنة بعشرة أمثالها، فترد لك أمثال الخير على هيئة فرح، يتجلى بألف مشهد وسيبدأ بابتسامة حتماً.
وبضعف مخلوقة شرقية تؤمن بالقدر، ولا تمتثل للملائكية كطريق منحه الله لبني آدم أن يخطئ مرة ويصيب مرة، تحاول أن تستكين للخير بقدر طيب ما استطعت إليه سبيلا، بنفس لوامة وقيم حرية مسؤولة، تؤمن أن ذرة النطفة فينا بعثت بروح المحبة من الله، ليأتي خلقه بأحسن تقويم في خلية الإنسان مئة بالمئة لا شذرة شذوذ فيها وإن النقص، وإن ورد فيها، سيبقى كامل الأوصاف لأنواع الناس، ذكورا وإناثاً ليعلموا أن سر الإنسان أن يحسن للإنسان.
حمل كتاب (وألقيت عليك محبة مني) صفات إيمانية عديدة، إذ يؤكد المؤلف أن الإحسان قد يوجد في كل شيء، وليس في أداء العبادات فقط إذ أن الدعاء والتسبيح ثم استواء الخُلق في معاملات الناس، إحسان عظيم عند الله، فكيف لو انتشر الإحسان كلاماً يؤثر في خَلقه، ويقود تربية النفس أولا ثم الأقربين فالأبعدين، فتتطور الأنساق الاجتماعية لتصبح أكثر سكينة ورحمة ومودة وتعارفاً، فالله خلق بيننا المودة والرحمة، وألزمها في علاقاتنا على العشق والكره، إذ أن المودة والرحمة عند الله أقوى لأوصال علاقاتنا، وأن اختلاف الناس بألوان وأعراق وأديان، ليس إلا لاستواء معرفة بني آدم أن يعمر أرض الله ويرعى مخلوقاته، فكيف تستوي رجاحة العقل بلا قلب محسن؟ كلما ضعف أمام ملذات الحياة، تذكر أن أجسادنا الفانية تضعف أمام فيروس لا يرى، مما يوجب علينا أن نحسن العناية باستواء الخُلق فينا، وإفناء العمر فيما يستحق، ليست السعادة في رفاهية زائلة فقط؛ بل في السعي للعلم أيضا.
حين باشرت كتابة المقدمة، كنت أجد صعوبة في بناء مخيم للكلمات لتهيئتها في ذهني، لتأخذ مستقرها في الأوصاف التي أتخيلها، حتى أستطيع أن أطبق جفوني على الكتاب رويدا رويدا، فكتاب يصف حالة كيف نرى الله، وكيف يرانا يجب أن يُقرأ ويتفحص برموش العينين هونا، إذ بالعادة يتوخى القلب أن يعترف لنفسه بالمحبة ويعاتبها على قدر الثقة، ليصعب على الكثيرين معرفة أين يقفون فعلا، خيرا أم شرا؟ أكان ابتلاء أم جزاء، فكثير منا يفضلون تجاوز تظلمات دواخلنا ويبررون الأفعال، لا سيما شرورها بما تقترفه ردود الأفعال اللحظية بمسطحات ظروف الحياة بدل مستوعباتها .
فنحن خُلقنا بمثلث قاعدته العمل بإتقان وسعي لا يعرف التواكل وضلعيه الأول الإحسان في الخُلق، والثاني الإقرار أن العلم نور ومعرفة ، فليس الكل يرى هذه المنفعة من الخَلق، فيكبر الكثيرون منا وهم يشعرون بالأسى ولا يعرفون المحبة كما وصفها الله في أول مسمى منحه لبني آدم (إنسان) ثم في كتبه السماوية وسيرة رسله وأخيرا في عباده المخلوقين من النور والنار والطين!
فلا يمكن ألا توصف حالة السكون والمنطق التي قد تلقى عليك في كتاب سعادة (وألقيت عليك محبة مني) إلا وأنت مستبشر بقدرتك على فهم وتدبر آيات القرآن الكريم التي يغيثها سعادة بنصوصه فوق سماء العقل وفي سويداء القلب، وهو يفسر معاني آيات الله بعيدا عن الإفتاء بالحلال والحرام والاكتفاء بمستقر هادئ دافع للطمأنينة، فتقرا كيف نتعامل مع أنفسنا بالإحسان، وكيف نجود أنفسنا ونهذبها ما أن نبدأ نسمع بالعيون، ونرى بالصبر، ونتلمس الحقيقة بالواقع، حتى ندرك جوهر الضرر في ضعف القلب لحظة انهزام، والقوة في دفعه لبناء عقل حضاري في لحظة انتصار.
والانهزام والانتصار يفصلهما عمق الإيمان...إيمانك بنفسك وما يجب أن تحب للإنسانية حتى تحب الله صافيا، لتُقدر ما تستطيع عليه، ولا تتهور في بناء شكل الانتصار، ولا تذوي أمام أي انهزام.
ووصف كيف نغذي الروح بالقرآن أمرا ليس سهلا أبدا، فأن تقرأ نصوص القرآن بتدبر وحدك ليس سهلا، لأن الكثيرين في ديننا قد يهمزون ويغمزون، فنحن أهل الكتابة والتحليل ولسنا بدارسين للشريعة الإسلامية، إنما قارئين نهمين بما فيه القرآن الكريم، أي أن الحقيقة تقول إن حب الله وتلاوة كتابه المحفوظ يمكن أن تتم بهمة عاشق لا بهتان في مشاعره، وسيتقن تدبره واستيعابه ولن يهبط في قلبه مستقرا إلا وكان فيه محبة حقا.
فكيف نحب الله ؟
سرد المؤلف كيف تكون الأمنية برؤية الله أن تدفعك لأن تستقر بطمأنينة، وأن تغلق عينيك وتتجلى في رؤية الله والتفكر فيما خلق الله من حولك، وأن الخير فينا يضيء شمعة اليقين، وأن رحمة الله تتسع وتأتي في موعدها، ثقة بالله فتراها كيفا التفت.
ويأخذنا كتاب سعادة لسردية الطمأنينة كثيرا ووصف مراحلها في مواضع عديدة ذكرت في القرآن الكريم، حتى لا يجفل قلب المؤمن ويرضى بقضائه وقدره وهذا بالطبع لا يجب أن يوقف فيه إرادة السعي والتوكل على الله، لأن نص التوكل على الله لا يعني أن تدعو الله ليلا نهارا وتعبده اعتكافا بلا سعي لبلوغ هدفك، والضلوع في عمارة الأرض وتذليل عثرات الحياة حتى تجد نفسك ومن تحب، فإن الله يحب عبده القوي، والقوي من لا يرضى بالمذلة، ولا يهون عليه الأذى، ولا يرقى لأن يأكل لحم أخيه، ولا أن يحاسب الناس على سرائرهم، ولا يستسلم في محاولة اكتشاف حقائق العلم والمعرفة، ويؤمن أن حقه في السعي لهدف انتقاه عن غيره ليس مستحيلا وان كل شيء ممكن.
ثم كيف يحبنا الله ؟
كتب علي سعادة كيف يربط الله على القلوب وكيف يبعث فيها القوة، كلما تسلحت بيقين العمل والإيمان والعلم بثلاثية محبة الله (فالعمل : إيمان، والمعرفة : علم، والخُلق : إحسان).
كيف نعيش المحبة ؟
كتب سعادة واقتبس منه : "ليس لك من الأمر شيئا : هو محاولة للفهم، وليس فلسفة أو تصوفاً، أنا أستفتي قلبي في فهم النص والجملة والحوار، وأتوقف عند الآيات التي يرشدني قلبي للتوقف عندها، الكاتب أسير الجملة تشده إليها رغما عنه" انتهى الاقتباس.
وهنا تؤكد مواضع إيمانية، حيث وردت في فلسفة سعادة أن تدبر الأمر لله تعالى أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا يقر أمر محاسبتهم أو إرجاعهم للسبيل قسراً ، إنما يكتفي بالتبليغ والإرشاد. إذ (عليك البلاغ وعلينا الحساب).
فليس لنا على أمر بعضنا بعض شيء، فالولاية لله في سريرة العباد وحده، فحين تريد أن تتحكم في الخلق يقال: ليس لك من الأمر شيئا في عباد الله.
إن كتاب (وألقيت عليك محبة مني) فلسفة لفهم عام للإنسانية في أجمل صورها، ثم للكون فإن جمعتا في فهم خاص ستفهم كيف تعيش بقيمة مضافة، ويكون نضالك في الحياة منظما فلا شأن لك فيما يقضي الفرد حياته فيه، لكن شأنك أن تكون أنت انعكاس لمحبة الله، والإحسان الذي يريد أن يراه عباده فيه، فيفعل الآخرون طبقا لسلوك الإنسان ما قد يكون جمعا بالفعل ومشاعا بين الناس... وكأنك تقول: سأعيش بخير لأن الله معي، وسأعيش بسعادة لأنني حاولت وسأحب لأنني استحق، وسأهزم حتى أتعلم فلا تعود قلبك على الحزن، لأن الهزائم من سنن الحياة وأن أجمل نصرٍ لا يأتي إلا بعد كدر ... كن على يقين أنك لست ضد التيار ولا معه بل أنت التيار، علم نفسك أن الحزن واجب، وأن الفرح فرض، وأن السعادة أن تقاوم وأن الانجاز أن تحاول ..
بنفسك محبة لله ثم للآخرين ... وكفى بالله وكيلا .
في صيف هذه السنة الضنكى على العباد، طلب مني الأستاذ علي سعادة أن أكتب مقدمة لكتابه (وألقيت عليك محبة مني) فشعرت بفضل زمالة تقاطعت فيها بناء الفكرة الراقية، وثقة الأخوة بيننا، بقدرتي على نسج نص مفعم بالمحبة يليق بكتاب خُصص ليرى الإنسانية بعين كاتبة أحبت الله وتدبرت كتابه، إذ كنت أقرأ نصوص الكتاب المتجلي في فلسفة تفسير كيف نرى الله ويرانا !
يزخر كتاب ( وألقيت عليك محبة مني) بثقافة حياتية من منظور عقائدي جميل جدا، إذ يتخذ سعادة من آيات القرآن الكريم تفاصيل صغيرة جدا ليفهم تركيبة السفينة التي ولدنا فيها، بمسمى القدر المبحرة بنا في محيط الحياة ، فتعلمنا أمواج الحياة ورياح القدر أن النضج لا يحتاج حساب للعمر بل حساب لمنظومة أفكارنا، وصياغة مبادئنا، وتأثيرات تكوينات معرفتنا، وأن كل محركات السفينة المبحرة بقدرنا، عليها أن تصل ضفة ما، للاستراحة وللمراجعة والتقييم والتحليل، وأن تلك الضفاف لا ترسو سفينتنا عليها صدفة، وأننا وحدنا من علينا أن نختار وأن الله يراقب خياراتنا ويدفع بالتي هي أحسن، بمشقاتها الكثيرة، وسعادتها الصغيرة، فكلما توسع الإيمان والاحتساب في قلوبنا الصغيرة، كلما فتحنا باباً جديداً، فقيل أن القدر من التقدير، وأمّا القضاء فهو الخَلق، فيكون القدَر بمنزلة الأساس، والقضاء بمنزلة البِناء، وكلما فهمنا مجريات طقس مسيرات السفينة، ومسببات أمواج بحر حياتنا، قدنا السفينة إلى ضفة تهيئ لنا أن نجد فيها شيئا من الحب والخير، فكلنا نعيش الخير والشر، ونحمل الجميل والبشع، الفرق بيننا أن يرابط أحدهم على الخير بصعب الحصول عليه أو يدفع بالسيئة الأسهل .
عندما قرأت كتاب سعادة، رأيت إحسان فلسفة نصوص هذا الكتاب بقلبي، لأتأمل آيات الله التي حللها سعادة، بسعادة وقناعة لأقتنع أن علي أن أكتب مقدمة تعبر عن كم الإحسان والإيثار الذي فاض به كتاب سعادة لأدفع غيري أن يرى الخير بالإحسان، وأن القرآن حمل محبة فائضة، تنير سبيل الضائع والمكلوم والمفجوع، وأن فلسفة المحبة في القرآن تبني أمما منتصبة الكرامة، في زمن طؤطئت فيه الرؤوس، حتى ظننا أن الشرق أضعف من أن يقف مجدداً إلى أن الحقيقة عكس ذلك.
من يتفحص نصوص هذا الكتاب، وتفاسير آيات القرآن بتمعن، يتغير شيء في وجدانه حالا، ما أن يغمض عينيه لليلة الأولى بعد قراءته، لأن إشراقا ما سينير قلبه وسيدفع بالخير فيه ليجود ويتسع على شر النفوس، لنقر أن اليوم الجديد ليس يوما عادياً من عمرك؛ بل هو يوم فيه حل لغز أمنية ما في نفسك، فتسعى في مناكب الأرض لتراها بشكل مختلف، فيفتح الله لك بابا من حيث تحتسب ولا تحتسب، لأن الأصل هو الحسنة بعشرة أمثالها، فترد لك أمثال الخير على هيئة فرح، يتجلى بألف مشهد وسيبدأ بابتسامة حتماً.
وبضعف مخلوقة شرقية تؤمن بالقدر، ولا تمتثل للملائكية كطريق منحه الله لبني آدم أن يخطئ مرة ويصيب مرة، تحاول أن تستكين للخير بقدر طيب ما استطعت إليه سبيلا، بنفس لوامة وقيم حرية مسؤولة، تؤمن أن ذرة النطفة فينا بعثت بروح المحبة من الله، ليأتي خلقه بأحسن تقويم في خلية الإنسان مئة بالمئة لا شذرة شذوذ فيها وإن النقص، وإن ورد فيها، سيبقى كامل الأوصاف لأنواع الناس، ذكورا وإناثاً ليعلموا أن سر الإنسان أن يحسن للإنسان.
حمل كتاب (وألقيت عليك محبة مني) صفات إيمانية عديدة، إذ يؤكد المؤلف أن الإحسان قد يوجد في كل شيء، وليس في أداء العبادات فقط إذ أن الدعاء والتسبيح ثم استواء الخُلق في معاملات الناس، إحسان عظيم عند الله، فكيف لو انتشر الإحسان كلاماً يؤثر في خَلقه، ويقود تربية النفس أولا ثم الأقربين فالأبعدين، فتتطور الأنساق الاجتماعية لتصبح أكثر سكينة ورحمة ومودة وتعارفاً، فالله خلق بيننا المودة والرحمة، وألزمها في علاقاتنا على العشق والكره، إذ أن المودة والرحمة عند الله أقوى لأوصال علاقاتنا، وأن اختلاف الناس بألوان وأعراق وأديان، ليس إلا لاستواء معرفة بني آدم أن يعمر أرض الله ويرعى مخلوقاته، فكيف تستوي رجاحة العقل بلا قلب محسن؟ كلما ضعف أمام ملذات الحياة، تذكر أن أجسادنا الفانية تضعف أمام فيروس لا يرى، مما يوجب علينا أن نحسن العناية باستواء الخُلق فينا، وإفناء العمر فيما يستحق، ليست السعادة في رفاهية زائلة فقط؛ بل في السعي للعلم أيضا.
حين باشرت كتابة المقدمة، كنت أجد صعوبة في بناء مخيم للكلمات لتهيئتها في ذهني، لتأخذ مستقرها في الأوصاف التي أتخيلها، حتى أستطيع أن أطبق جفوني على الكتاب رويدا رويدا، فكتاب يصف حالة كيف نرى الله، وكيف يرانا يجب أن يُقرأ ويتفحص برموش العينين هونا، إذ بالعادة يتوخى القلب أن يعترف لنفسه بالمحبة ويعاتبها على قدر الثقة، ليصعب على الكثيرين معرفة أين يقفون فعلا، خيرا أم شرا؟ أكان ابتلاء أم جزاء، فكثير منا يفضلون تجاوز تظلمات دواخلنا ويبررون الأفعال، لا سيما شرورها بما تقترفه ردود الأفعال اللحظية بمسطحات ظروف الحياة بدل مستوعباتها .
فنحن خُلقنا بمثلث قاعدته العمل بإتقان وسعي لا يعرف التواكل وضلعيه الأول الإحسان في الخُلق، والثاني الإقرار أن العلم نور ومعرفة ، فليس الكل يرى هذه المنفعة من الخَلق، فيكبر الكثيرون منا وهم يشعرون بالأسى ولا يعرفون المحبة كما وصفها الله في أول مسمى منحه لبني آدم (إنسان) ثم في كتبه السماوية وسيرة رسله وأخيرا في عباده المخلوقين من النور والنار والطين!
فلا يمكن ألا توصف حالة السكون والمنطق التي قد تلقى عليك في كتاب سعادة (وألقيت عليك محبة مني) إلا وأنت مستبشر بقدرتك على فهم وتدبر آيات القرآن الكريم التي يغيثها سعادة بنصوصه فوق سماء العقل وفي سويداء القلب، وهو يفسر معاني آيات الله بعيدا عن الإفتاء بالحلال والحرام والاكتفاء بمستقر هادئ دافع للطمأنينة، فتقرا كيف نتعامل مع أنفسنا بالإحسان، وكيف نجود أنفسنا ونهذبها ما أن نبدأ نسمع بالعيون، ونرى بالصبر، ونتلمس الحقيقة بالواقع، حتى ندرك جوهر الضرر في ضعف القلب لحظة انهزام، والقوة في دفعه لبناء عقل حضاري في لحظة انتصار.
والانهزام والانتصار يفصلهما عمق الإيمان...إيمانك بنفسك وما يجب أن تحب للإنسانية حتى تحب الله صافيا، لتُقدر ما تستطيع عليه، ولا تتهور في بناء شكل الانتصار، ولا تذوي أمام أي انهزام.
ووصف كيف نغذي الروح بالقرآن أمرا ليس سهلا أبدا، فأن تقرأ نصوص القرآن بتدبر وحدك ليس سهلا، لأن الكثيرين في ديننا قد يهمزون ويغمزون، فنحن أهل الكتابة والتحليل ولسنا بدارسين للشريعة الإسلامية، إنما قارئين نهمين بما فيه القرآن الكريم، أي أن الحقيقة تقول إن حب الله وتلاوة كتابه المحفوظ يمكن أن تتم بهمة عاشق لا بهتان في مشاعره، وسيتقن تدبره واستيعابه ولن يهبط في قلبه مستقرا إلا وكان فيه محبة حقا.
فكيف نحب الله ؟
سرد المؤلف كيف تكون الأمنية برؤية الله أن تدفعك لأن تستقر بطمأنينة، وأن تغلق عينيك وتتجلى في رؤية الله والتفكر فيما خلق الله من حولك، وأن الخير فينا يضيء شمعة اليقين، وأن رحمة الله تتسع وتأتي في موعدها، ثقة بالله فتراها كيفا التفت.
ويأخذنا كتاب سعادة لسردية الطمأنينة كثيرا ووصف مراحلها في مواضع عديدة ذكرت في القرآن الكريم، حتى لا يجفل قلب المؤمن ويرضى بقضائه وقدره وهذا بالطبع لا يجب أن يوقف فيه إرادة السعي والتوكل على الله، لأن نص التوكل على الله لا يعني أن تدعو الله ليلا نهارا وتعبده اعتكافا بلا سعي لبلوغ هدفك، والضلوع في عمارة الأرض وتذليل عثرات الحياة حتى تجد نفسك ومن تحب، فإن الله يحب عبده القوي، والقوي من لا يرضى بالمذلة، ولا يهون عليه الأذى، ولا يرقى لأن يأكل لحم أخيه، ولا أن يحاسب الناس على سرائرهم، ولا يستسلم في محاولة اكتشاف حقائق العلم والمعرفة، ويؤمن أن حقه في السعي لهدف انتقاه عن غيره ليس مستحيلا وان كل شيء ممكن.
ثم كيف يحبنا الله ؟
كتب علي سعادة كيف يربط الله على القلوب وكيف يبعث فيها القوة، كلما تسلحت بيقين العمل والإيمان والعلم بثلاثية محبة الله (فالعمل : إيمان، والمعرفة : علم، والخُلق : إحسان).
كيف نعيش المحبة ؟
كتب سعادة واقتبس منه : "ليس لك من الأمر شيئا : هو محاولة للفهم، وليس فلسفة أو تصوفاً، أنا أستفتي قلبي في فهم النص والجملة والحوار، وأتوقف عند الآيات التي يرشدني قلبي للتوقف عندها، الكاتب أسير الجملة تشده إليها رغما عنه" انتهى الاقتباس.
وهنا تؤكد مواضع إيمانية، حيث وردت في فلسفة سعادة أن تدبر الأمر لله تعالى أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا يقر أمر محاسبتهم أو إرجاعهم للسبيل قسراً ، إنما يكتفي بالتبليغ والإرشاد. إذ (عليك البلاغ وعلينا الحساب).
فليس لنا على أمر بعضنا بعض شيء، فالولاية لله في سريرة العباد وحده، فحين تريد أن تتحكم في الخلق يقال: ليس لك من الأمر شيئا في عباد الله.
إن كتاب (وألقيت عليك محبة مني) فلسفة لفهم عام للإنسانية في أجمل صورها، ثم للكون فإن جمعتا في فهم خاص ستفهم كيف تعيش بقيمة مضافة، ويكون نضالك في الحياة منظما فلا شأن لك فيما يقضي الفرد حياته فيه، لكن شأنك أن تكون أنت انعكاس لمحبة الله، والإحسان الذي يريد أن يراه عباده فيه، فيفعل الآخرون طبقا لسلوك الإنسان ما قد يكون جمعا بالفعل ومشاعا بين الناس... وكأنك تقول: سأعيش بخير لأن الله معي، وسأعيش بسعادة لأنني حاولت وسأحب لأنني استحق، وسأهزم حتى أتعلم فلا تعود قلبك على الحزن، لأن الهزائم من سنن الحياة وأن أجمل نصرٍ لا يأتي إلا بعد كدر ... كن على يقين أنك لست ضد التيار ولا معه بل أنت التيار، علم نفسك أن الحزن واجب، وأن الفرح فرض، وأن السعادة أن تقاوم وأن الانجاز أن تحاول ..
بنفسك محبة لله ثم للآخرين ... وكفى بالله وكيلا .