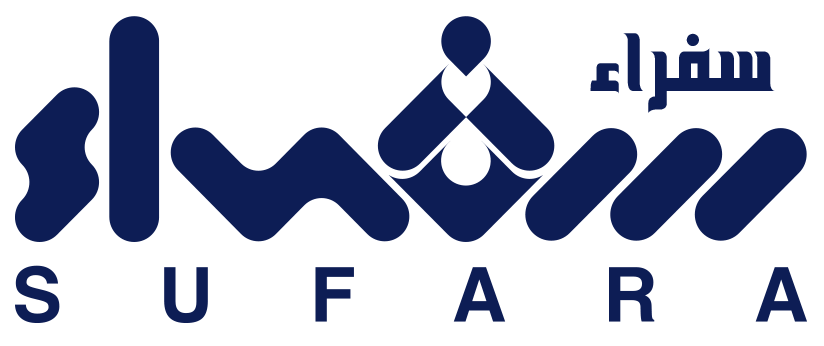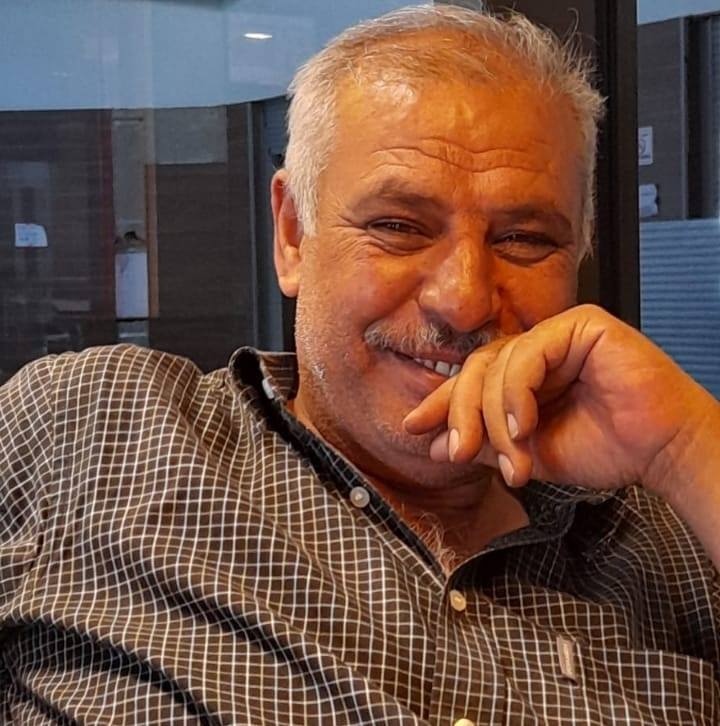سجّل شعراء الجاهلية تفاصيل المجتمع العربي قبل الإسلام بكل ما فيه من معتقدات وصراعات وأحداث، ذات دلالات اجتماعية أو سياسية أو ثقافية، وهو ما يمكن رصده في نماذج عدة، تتصل بحياة سكان مدينة يثرب قبل هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) إليها، حيث نراها بداية في سردية تنصيب الصنم مَنَاة ليكون إلها للأوس والخزرج في يثرب، بعدما استقر بهم المقام فيها، وقيل قد تم تنصيبه بالقرب من يثرب، وكانوا يذهبون إليه، ويقدمون القرابين، ويحلقون رؤوسهم تحته، وذلك بعد عودتهم من الحج وفي هذا يقول أحد الشعراء على نحو ما يذكر الكلبي في كتابه الأصنام:
إني حلفتُ يمينَ صدق برةً بمناة عند محل آل الخزرج
وقد بلغ تعظيمهم لمناة، أنهم لا يولون ظهورهم إليها، وإنما ينحرفون يمنة أو يسرة حتى لا تكون خلفهم، ويغادرون موقعها، وفي ذلك يقول الشاعر الكميت:
وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها متحرفين
ويتضح من خلال الاستشهاد السابق كيف أن الشاعر العربي في الجاهلية كان يعبر عن مشاعر قومه الدينية، وكيف يصف سلوكياتهم إزاء المقدسات. ولندرك أن أهل يثرب اتبعوا ما وجدوا عليه القبائل العربية من معتقدات الشرك والوثنية، وعظموا في الوقت نفسه شعائر الحج المتوارثة عن الديانة الحنفية، ولم يتقبلوا الديانة اليهودية، على الرغم من وجودهم في قرى محصنة حول يثرب، لكنهم حبسوا أنفسهم، ومارسوا عباداتهم في معابدهم داخل آطامهم، ولم يسعوا إلى نشر عقائدهم بين عرب يثرب.
الاستشهاد الشعري الثاني جاء رثاء من قبل أحد الشعراء للعبيلين، وهم أول من سكنوا يثرب، واحترفوا فيها الزراعة، وقد أورد الأبيات المسعودي صاحب «مروج الذهب»:
عين عودي على عبيل وهـل يرجع ما فات فيضها بانسجام
عمّروا يثرب وليس فيها سفر ولا سارح ولا ذو سنام
غرسوا لينها ببحر معين ثم حفّوا الفسيل بالآجام
وقد وفد العبيليون من بلاد سومر في العراق، وقدموا إلى موضع يثرب، الذي هو واحة في الأساس، تمتلئ بالينابيع والمياه الجوفية، فأينما حفروا الآبار تفجرت بالماء العذب، ولذا قال عنها العرب إنها أشجر بلاد الحجاز. وقد حمل العبيليون خبراتهم في الزراعة، فعمدوا إلى تعمير يثرب واستزراعها، وملأوها بالبساتين والحقول. تحمل الأبيات السابقة إخبارا بالتاريخ، بالإشارة إلى عبيليين كونهم سببا للاقتصاد الزراعي الذي تميزت به يثرب، فالقبائل العربية التي عاشت في الحجاز كانت البداوة طبيعة لها، ولم تسعَ إلى التحضر بالاستقرار في القرى، وفلاحة الأرض، وهو ما تحقق على يد العبيليين، الذين هاجروا من العراق لأسباب عدة، ووجدوا في أرض يثرب ملاذا وعيشا وبيئة زراعية لهم، وفي الأبيات إشارة إلى فضلهم في تعمير يثرب، التي كانت أرضا مهجورة يوما، فغرسوا فيها اللِين (الأشجار) واستنبتوا الفسائل، وكذلك فعل اليهود الذي خبروا الزراعة، عندما هاجروا واستقروا في يثرب.
كما يرد الشعر بوصفه سجلاً لموقف شجاع ذي دلالة ثقافية، حيث تحدى الشاعر المعروف عروة بن الورد ما روّجه يهود يثرب بين الأوس والخزرج من مقولات مفادها، أن أي غريب عن يثرب إذا أراد دخولها فلا بد من أن يلجَ من «ثنية الوداع» وعليه أن يعشّر أي ينهق مثل الحمار عشر مرات، فإذا دخلها من غيرها أصيب بمرض قاتل. وقد حاور عروةُ اليهودَ قائلا: يا معشر يهود، ما لكم والتعشير! فقالوا: إنه لم يدخلها أحد من غير أهلها، فلم يعشّر بها إلا مات. ولا يدخلها أحد من غير ثنية الوداع إلا أصابه الهزال. فلم يبال بهم عروة، ودخلها على أعين الناس، وهم يترقبون أن تصيبه مصيبة، وأنشد يقول:
لعمري لئن عشّرتُ من خشية الردى نهاق الحمير إنني لجزوع
وتبعه الناس بعد ذلك في ما فعل، وأبطلوا مقولة يهود.
والموقف دال على تخرصات اليهود وما أشاعوه من خرافات بين أهل يثرب، دون دليل ملموس، سواء من كتبهم الدينية، أو من تجاربهم في الحياة، وللأسف فإن الناس صدقوهم، حتى جاء عروة بن الورد الذي أعمل عقله في أكذوبة كهذه، ومن ثم قرن الفعل بالقول، ووقف أهل يثرب يتأملون مشهد ولوجه، الذي خلّده ببيت شعري.
ومعلوم أن اليثربيين عُرِفوا بالثقافة العربية والذوق الرفيع، ونقدهم الجمالي الصائب، وقد حضر النابعة الذبياني ذات مرة إليهم، وكان اليثربيون قد سمعوا قصيدة له فيها إقواء، فأرادوا تنبيهه بطريقة غير مباشرة، فأمروا جارية عندهم أن تغني القصيدة، وتمدّ صوتها في المواضع التي فيها إقواء، من مثل قوله:
أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودِ
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسودُ
وقوله في القصيدة أيضا:
بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقدُ
فتنبه النابغة للعيب، وعدّل أبياته ليتخلص من الإقواء، فعدل الشطر الأخير من البيت الثاني ليكون: وبذاك تنعاب الغراب الأسود. والشطر الأخير من البيت الثالث ليكون: عنم على أغصانه لم يعقدِ.
إنه موقف دال على ذائقة أهل يثرب الراقية، وكيف أنهم يمتازون بالبلاغة والفصاحة، وأيضا الرقة في توجيه النقد، فجاء عبر غناء ماتع، وإشارة خفية، أدركها النابغة، وهو من هو في الشعر والمكانة السامقة بين الناس، وقد وضعه ابن سلام الجمحي في الطبقة الأولى من الشعراء في كتابه «طبقات فحول الشعراء» ومعروف عنه أنه من كبار النقاد العرب في الجاهلية، حيث كانت تُضرَب له قبَّةٌ حمراءُ مِن جِلد في سوق عكاظ، حيث يقوم النابغةَ بالحُكمَ على الكثير من القصائد. وشهد له عدد من الشعراء، حيث قالوا عن شعره: كان أحسنهم ديباجة شعر، وأكثرهم رونق كلام، وأجزلهم بيتا. كأن شعره كلام ليس فيه تكلّف، ومع ذلك تقبل نقد أهل يثرب له، وعدّل قصيدته فور تنبيهه.
وهذا برهان على رسوخ العربية بلاغة وشعرا وإبداعا وتلَقّيا لدى اليثربيين، وهو ما جعلهم يتذوقون القرآن الكريم وإعجازه البلاغي، وتعاطوا مع بلاغة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو ما ميّزهم عن أهل مكة الذين تعاملوا بفظاظة وتكبر وتعنت مع الرسول.
إني حلفتُ يمينَ صدق برةً بمناة عند محل آل الخزرج
وقد بلغ تعظيمهم لمناة، أنهم لا يولون ظهورهم إليها، وإنما ينحرفون يمنة أو يسرة حتى لا تكون خلفهم، ويغادرون موقعها، وفي ذلك يقول الشاعر الكميت:
وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها متحرفين
ويتضح من خلال الاستشهاد السابق كيف أن الشاعر العربي في الجاهلية كان يعبر عن مشاعر قومه الدينية، وكيف يصف سلوكياتهم إزاء المقدسات. ولندرك أن أهل يثرب اتبعوا ما وجدوا عليه القبائل العربية من معتقدات الشرك والوثنية، وعظموا في الوقت نفسه شعائر الحج المتوارثة عن الديانة الحنفية، ولم يتقبلوا الديانة اليهودية، على الرغم من وجودهم في قرى محصنة حول يثرب، لكنهم حبسوا أنفسهم، ومارسوا عباداتهم في معابدهم داخل آطامهم، ولم يسعوا إلى نشر عقائدهم بين عرب يثرب.
الاستشهاد الشعري الثاني جاء رثاء من قبل أحد الشعراء للعبيلين، وهم أول من سكنوا يثرب، واحترفوا فيها الزراعة، وقد أورد الأبيات المسعودي صاحب «مروج الذهب»:
عين عودي على عبيل وهـل يرجع ما فات فيضها بانسجام
عمّروا يثرب وليس فيها سفر ولا سارح ولا ذو سنام
غرسوا لينها ببحر معين ثم حفّوا الفسيل بالآجام
وقد وفد العبيليون من بلاد سومر في العراق، وقدموا إلى موضع يثرب، الذي هو واحة في الأساس، تمتلئ بالينابيع والمياه الجوفية، فأينما حفروا الآبار تفجرت بالماء العذب، ولذا قال عنها العرب إنها أشجر بلاد الحجاز. وقد حمل العبيليون خبراتهم في الزراعة، فعمدوا إلى تعمير يثرب واستزراعها، وملأوها بالبساتين والحقول. تحمل الأبيات السابقة إخبارا بالتاريخ، بالإشارة إلى عبيليين كونهم سببا للاقتصاد الزراعي الذي تميزت به يثرب، فالقبائل العربية التي عاشت في الحجاز كانت البداوة طبيعة لها، ولم تسعَ إلى التحضر بالاستقرار في القرى، وفلاحة الأرض، وهو ما تحقق على يد العبيليين، الذين هاجروا من العراق لأسباب عدة، ووجدوا في أرض يثرب ملاذا وعيشا وبيئة زراعية لهم، وفي الأبيات إشارة إلى فضلهم في تعمير يثرب، التي كانت أرضا مهجورة يوما، فغرسوا فيها اللِين (الأشجار) واستنبتوا الفسائل، وكذلك فعل اليهود الذي خبروا الزراعة، عندما هاجروا واستقروا في يثرب.
كما يرد الشعر بوصفه سجلاً لموقف شجاع ذي دلالة ثقافية، حيث تحدى الشاعر المعروف عروة بن الورد ما روّجه يهود يثرب بين الأوس والخزرج من مقولات مفادها، أن أي غريب عن يثرب إذا أراد دخولها فلا بد من أن يلجَ من «ثنية الوداع» وعليه أن يعشّر أي ينهق مثل الحمار عشر مرات، فإذا دخلها من غيرها أصيب بمرض قاتل. وقد حاور عروةُ اليهودَ قائلا: يا معشر يهود، ما لكم والتعشير! فقالوا: إنه لم يدخلها أحد من غير أهلها، فلم يعشّر بها إلا مات. ولا يدخلها أحد من غير ثنية الوداع إلا أصابه الهزال. فلم يبال بهم عروة، ودخلها على أعين الناس، وهم يترقبون أن تصيبه مصيبة، وأنشد يقول:
لعمري لئن عشّرتُ من خشية الردى نهاق الحمير إنني لجزوع
وتبعه الناس بعد ذلك في ما فعل، وأبطلوا مقولة يهود.
والموقف دال على تخرصات اليهود وما أشاعوه من خرافات بين أهل يثرب، دون دليل ملموس، سواء من كتبهم الدينية، أو من تجاربهم في الحياة، وللأسف فإن الناس صدقوهم، حتى جاء عروة بن الورد الذي أعمل عقله في أكذوبة كهذه، ومن ثم قرن الفعل بالقول، ووقف أهل يثرب يتأملون مشهد ولوجه، الذي خلّده ببيت شعري.
ومعلوم أن اليثربيين عُرِفوا بالثقافة العربية والذوق الرفيع، ونقدهم الجمالي الصائب، وقد حضر النابعة الذبياني ذات مرة إليهم، وكان اليثربيون قد سمعوا قصيدة له فيها إقواء، فأرادوا تنبيهه بطريقة غير مباشرة، فأمروا جارية عندهم أن تغني القصيدة، وتمدّ صوتها في المواضع التي فيها إقواء، من مثل قوله:
أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودِ
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسودُ
وقوله في القصيدة أيضا:
بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقدُ
فتنبه النابغة للعيب، وعدّل أبياته ليتخلص من الإقواء، فعدل الشطر الأخير من البيت الثاني ليكون: وبذاك تنعاب الغراب الأسود. والشطر الأخير من البيت الثالث ليكون: عنم على أغصانه لم يعقدِ.
إنه موقف دال على ذائقة أهل يثرب الراقية، وكيف أنهم يمتازون بالبلاغة والفصاحة، وأيضا الرقة في توجيه النقد، فجاء عبر غناء ماتع، وإشارة خفية، أدركها النابغة، وهو من هو في الشعر والمكانة السامقة بين الناس، وقد وضعه ابن سلام الجمحي في الطبقة الأولى من الشعراء في كتابه «طبقات فحول الشعراء» ومعروف عنه أنه من كبار النقاد العرب في الجاهلية، حيث كانت تُضرَب له قبَّةٌ حمراءُ مِن جِلد في سوق عكاظ، حيث يقوم النابغةَ بالحُكمَ على الكثير من القصائد. وشهد له عدد من الشعراء، حيث قالوا عن شعره: كان أحسنهم ديباجة شعر، وأكثرهم رونق كلام، وأجزلهم بيتا. كأن شعره كلام ليس فيه تكلّف، ومع ذلك تقبل نقد أهل يثرب له، وعدّل قصيدته فور تنبيهه.
وهذا برهان على رسوخ العربية بلاغة وشعرا وإبداعا وتلَقّيا لدى اليثربيين، وهو ما جعلهم يتذوقون القرآن الكريم وإعجازه البلاغي، وتعاطوا مع بلاغة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو ما ميّزهم عن أهل مكة الذين تعاملوا بفظاظة وتكبر وتعنت مع الرسول.
القدس العربي
كاتب مصري//محمد مصطفى عطية